العدالة لا تنهار بانقلاب أو عدوان فقط، بل تنهار بصمت حين يستبيح الناس اللاعدالة، ويعتبرون اللغط حقًا مكتسبًا، وإذا ما أردنا أن ننهض بوطنٍ يُنصف أبناءه، فعلينا أن نُعيد بناء الوظيفة العامة على أساس المساواة والاستحقاق، فالله لا يرضى الظلم، والرسول لا يقر التمييز، والقانون لا يحتمل التجزئة...
العدالة الاجتماعية هي الركن الأهم في بناء أي مجتمع متوازن يُنصف أفراده في الفرص والحقوق والواجبات، لكن ما إن تترسّخ في الواقع ظواهر كـالواسطة والمحسوبية، حتى تُنسف هذه العدالة من جذورها، ويصبح النجاح حكرًا على من يعرف مَن، لا على من يعرف كيف، وحين تسود الواسطة على الكفاءة، فإننا لا نخسر العدالة فقط بل نخسر الدولة ذاتها، ونحوّل الوظيفة العامة إلى تركة توزّعها المصالح لا القانون، الواسطة تعني التوسّط لدى جهة ما لصالح شخص، بغضّ النظر عن أهليته، وغالبًا ما تتم خارج إطار القانون، وبما يتجاوز الكفاءة أو الاستحقاق، والمحسوبية تعني تفضيل الأقارب أو الأصدقاء أو المنتمين لنفس الحزب أو الطائفة في التعيين أو الترقية أو الفرص، على حساب الكفاءة والمساواة، وقد تُغلَّف هذه الظواهر بأسماء اجتماعية مثل (عونة أو فزعة أو مساعدة)، لكنها في الحقيقة انتهاك صارخ لمبدأ العدالة، وانحراف عن جوهر الوظيفة العامة كمؤسسة لخدمة الجميع.
أدان الإسلام المحسوبيات والوساطات التي تُقوّض العدل، وعدّها من وجوه الظلم، حتى لو كانت باسم القربى أو الشفاعة، ففي الحديث النبوي الشريف، حين أراد بعض الصحابة الشفاعة في حدٍّ شرعي لامرأة من بني مخزوم، غضب النبي (ص) وقال: "أتشفع في حد من حدود الله؟! والله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها" وحاشاها مولاتنا من الفعل، لكن هذا الموقف النبوي يُشكّل أبلغ ردّ على من يبرّر التمييز العائلي أو السياسي في تطبيق العدالة، بل جعل الإسلام تقديم غير الأكفّاء في المناصب خيانة، ففي الحديث: "من استعمل رجلًا على عصابة، وفيهم من هو أرضى لله منه، فقد خان الله ورسوله والمؤمنين"، فالخيانة هنا ليست سرقة مال فقط، بل تقديم غير المستحق لمكان لا يستحقه.
ليست الواسطة مجرّد خلل أخلاقي، بل هي أحد أهم أوجه الفساد الإداري، حيث تُقتل الكفاءات وتُغتال فرص الشباب غير المرتبطين بنفوذ، ويتحوّل الجهاز الوظيفي إلى طبقية خفيّة قائمة على من يحظى بالدعم، وعليه يفقد المواطن الثقة بمؤسسات الدولة، ويشعر بالاغتراب في وطنه، والأسوأ من ذلك، أن المحسوبية تُنتج مؤسسات هشّة، تُدار بلا كفاءة، وتُحصّن نفسها ضد المحاسبة، لأن القيادات ليست ثمرة كفاءة، بل نتاج ولاء متبادل.
رغم أن القانون العراقي لم يستخدم لفظ الواسطة والمحسوبية صراحة، إلا أنه يُجرّم سوء استخدام الوظيفة العامة عند الاخلال العمدي بواجبات الوظيفة العامة ولدى استغلال الوظيفة لمصلحة شخصية أو اضرار بالأغيار، ونص على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في التعيين والتوظيف، كما في قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل، والدستور العراقي لسنة 2005، المادة (16) التي تنص على: "تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك"، لكن تبقى المشكلة في ضعف تطبيق هذه النصوص، وسط انتشار الثقافة السائدة بأن الواسطة حق طبيعي بما أن الامور لا تسير إلا بها!، مما يُفرغ القانون من مضمونه، ويُكرّس اللاعدالة.
ومما تقدم يتضح لنا أنّ التحصين القانوني لا يكفي وحده، بل لابدّ من إصلاح ثقافي–ديني يعيد تعريف الوظيفة كمجال تكليف لا مجال نفوذ، وإلزام مؤسسات الدولة بمبدأ الشفافية في التعيينات والترقيات، وتفعيل مبدأ الإفصاح عن تضارب المصالح والمحسوبية العائلية والسياسية، وإشراك المجتمع المدني والإعلام في الرقابة على نزاهة إجراءات التوظيف، وكذلك في إعادة الاعتبار للكفاءة والمعايير الموضوعية في إدارات الدولة.
ختامًا- العدالة لا تنهار بانقلاب أو عدوان فقط، بل تنهار بصمت حين يستبيح الناس اللاعدالة، ويعتبرون اللغط حقًا مكتسبًا، وإذا ما أردنا أن ننهض بوطنٍ يُنصف أبناءه، فعلينا أن نُعيد بناء الوظيفة العامة على أساس المساواة والاستحقاق، فالله لا يرضى الظلم، والرسول لا يقر التمييز، والقانون لا يحتمل التجزئة، وفي قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ (النساء: 58) وما الوظيفة والعمل إلا أمانة، وأهلها هم الأكفّاء، لا الأقرباء.


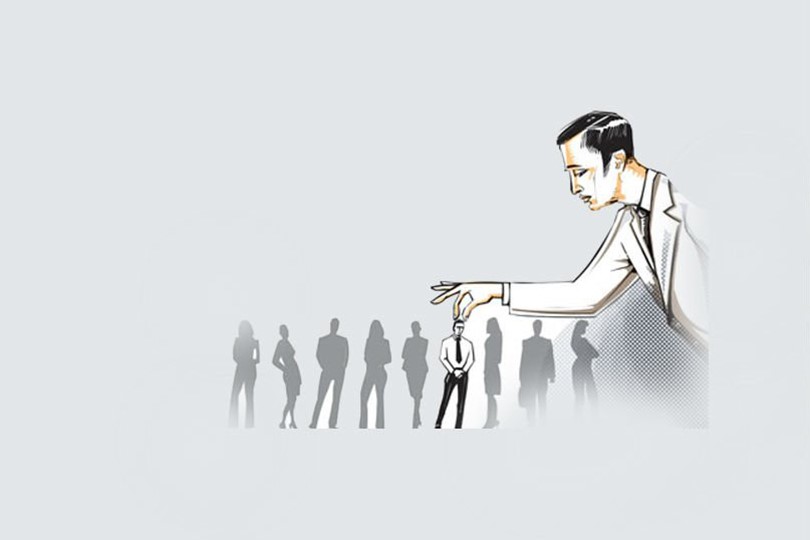

اضف تعليق